نصار ابراهيم يكتب ...|التطرف والإرهاب الديني: مجرد انحراف نفسي – فكري، أم مشروع مدروس؟
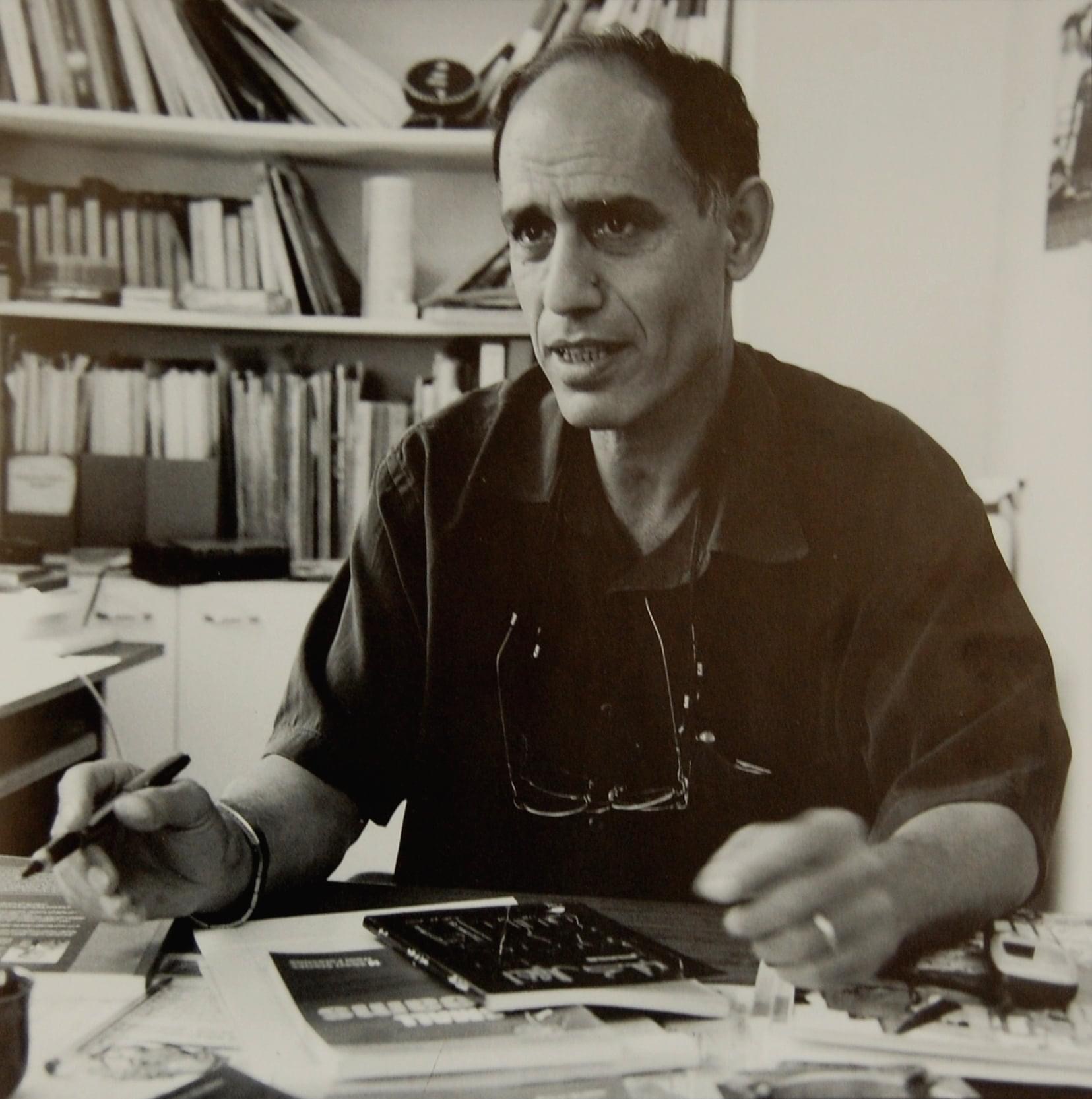
هناك فرق شاسع ما بين الحرية المسؤولة القائمة على العقل والاحترام، والواجب والتكامل والتفاعل الإنساني و"الحرية" القائمة على الإساءة والإقصاء والعنصرية والعنف والتطرف والكراهية.
وعليه، عندما يصبح الإنسان والمجتمع/الشعب وهويته وانتمائه ووحدته ومصالحه في مرمى نيران الجهل والتحريض وتحريك الغرائز فإن وجود الإنسان بذاته يصبح حطبا لنيران تلك الكراهية والعنصرية البغيضة. في مثل هذه الحالة يصبح من الواجب والضرورة أن ينتفض المجتمع والنخب الثقافية والدينية المتنورة وغيرها، لحماية المجتمع من السقوط في متاهة التدمير الذاتي الأخلاقي والمعنوي والضحالة الفكرية والسلوكية مهما كانت الراية التي يجري تحتها ذلك، سواء كان الفعل السياسي أو الاقتصادي أو الأيديولوجي أو الاجتماعي.
نقطة الانطلاق في هذا النقاش، هي أن الدين ليس حكرا على فئة أو جماعة مهما كانت درجة انتظامها واعتدادها بذاتها، ذلك لأن الدين بقدر ما هو ظاهرة إلهية عند البعض فإنه عند آخرين ظاهرة اجتماعية تاريخية، وفي الحالتين فإنه حقيقة قائمة وممتدة تلقي بآثارها على مجمل المجتمع، سواء من يؤمن به أو لم يؤمن. ذلك لأن الدين ليس مجرد طقوس وممارسات وشعائر ومشاعر، بل هو أيضا إيمان جماعي وفردي ينعكس في السلوك والثقافة والنواظم الاجتماعية بصورة عميقة. بهذا المعنى فإن الأديان في المجتمع هي ملك لجميع المواطنين ذلك لأنها مكون ينعكس في حياة وسلوك وأداء المجتمع على مختلف المستويات.
أفهم الدين، كما يقدم نفسه، على أنه "تدخل سماوي واستجابة من الإنسان من أجل حريته وسعادته على الأرض كما في السماء"… (فالله من حيث المبدأ ليس بحاجة للناس) ولهذا فإن جميع الأديان والأنبياء والكتب السماوية (وحتى غير السماوية) تبدأ دائما بالتصدى للجهل والظلم والقهر، أي الاختلالات القائمة في المجتمعات، ومن خلال دورها هذا تبرهن رسالتها وجدواها، أي من خلال التصدي لمشاكل الناس المباشرة الروحية والمادية، هكذا يقدم الدين نفسه من حيث المبدأ ونقطة الأصل، أي كوسيلة لتحرير الأنسان روحيا وجسديا ماديا واجتماعيا. بمعنى أن الله أرسل الرسل والأنبياء من أجل مساعدة الإنسان على حل المشاكل التي تجابهه وليس من أجل حل مشاكل الله، ولو أراد الله أن يحل مشاكل الناس بالقوة والعنف كما تفعل القوى الدينية المتطرفة، سواء كانت تنظيمات أو جماعات أم دولا استعمارية، لما احتاج لأي تنظيم أو جماعة أو دولة، لكنه لم يفعل ذلك لأن ليس هذا هو جوهر الدين ولا رسالته أو وظيفته
فالدين كما يقدم نفسه بالأصل ليس أداة أو وسيلة للسيطرة والقهر، بل معتقدات وإيمان وعبادات وفضاء وممارسة تقوم على التفاعل والاحترام حتى مع من يختلف مع المقاربات الدينية، وغير ذلك يعني الضياع والقطع مع المجتمع والصيرورات التاريخية لبناء المجتمعات الإنسانية، مما يستدعي التصدي لعمليات حرف الدين وتفريغه من محتواه وجوهره كما بشر به الأنبياء والرسل وتحويله إلى دين وتدين شكلي ملتبس، تدين ظلامي فاقد لعمقه وروحه وإنسانيته، وصولا إلى التطرف والتعصب وما يترتب على ذلك من عنف يهدد حياة الانسان ووحدة الشعوب والسلم الأهلي.
. لكن ما حدث هو أن الدين في سياق هذه العملية الطويلة والمعقدة والمركبة واجه ويواجه تحديا أساسيا نقيضا وهو: مدى قدرته على حماية ذاته كرسالة وعقيدة ومؤسسات بحيث لا يتحول إلى أداة قهر في يد السلطة السياسية (دولة، قوى سياسية) أو أي قوة اجتماعية بهدف إخضاع المجتمع وتبرير الظلم أو الاستعمار أو الاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
بهذا المعنى فإن الدين كما يقدم نفسه، هو قوة تغيير إيجابية للواقع وليس مجرد وعظ ومناشدات أخلاقية، أي أنه بقدر ما للدين من مرجعية ووظيفة روحية وإيمانية سماوية، بقدر ما يجب أن يكون دوره عملي وميداني بين الناس، أي دور فاعل ومشارك في المقاومة من أجل التغيير وإنهاء الظلم والقهر والاستغلال، وليس مجرد الوعظ والتمني والصلاة. فالصلاة ليست بديلا عن الفعل الإنساني بل هي قوة إسناد روحية ومعنوية لذلك الفعل.
هنا بالضبط يتجلى جذر التطرف الديني بمعنى: عندما يتخلى الدين "ورجال الدين والمؤمنون" والمثقفون عن دورهم ويسمحوا بمصادرة الدين من قبل السلطة السياسية أو أية قوى أخرى، وفي السياق يقبلوا أن يصبحوا هم أيضا أدوات مأجورة في يد تلك السلطة ومشاريعها ، عندها يصبح الدين ورجال الدين مجرد قوة إخضاع وسيطرة وتبرير لسياسات القهر والظلم ، حينها يتم ترك الميدان ليملؤه من يشاء وكيف يشاء.
ولهذا قال كارل ماركس يوما: الأيديولوجيا دائما مصابة بزكام عدم التحول إلى واقع، (بما في ذلك الدين).
إذن المهمة الأساسية الأولى هي تحرير الدين ومؤسساته وثقافته من مصيدة الرهاب الديني ودين مؤسسة الدولة القهرية، لكي يستعيد دوره الأساسي كقوة فعل ومقاومة اجتماعية وثقافية شاملة في مواجهة الظلم والقهر والاستغلال بكافة اشكاله (هذا ما نجح به لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية عندما وقف إلى جانب الناس والفقراء ومقاومة الهيمنة والاستعمار، وفي واقعنا العربي هناك أيضا بعض قوى المقاومة التي تتبنى الأيديولوجيا الدينية اتخذت نفس هذا المسار).
لقد تزايد وتوسع استخدام وتوظيف التطرف الديني وحوامله السياسية والفكرية من قبل القوى السياسية المحلية والدولية لخدمة أهداف سياسية واقتصادية تتناقض مع مصالح الشعوب والأمم.
ما هو التطرف؟:
التطرف هو اتجاه عقلي وحالة نفسية تقوم على التعصب للجماعة أو الرأي أو المعتقد، مما يقود إلى الكراهية التي تستند إلى حكم عام قائم على الجمود، لهذا فإن التطرف هو حالة وممارسة في حقيقتها تخالف سُنَّة الكون في التفاعل والتطور وضرورة التنوع، وتتجاوز الحدود التي وضعها ويرضاها المجتمع، فتنحرف عن العقلانية المطلوبة لمعايير التفكير والسلوك. إنها نوع من التمركز الجامد حول الذات سواء كفرد أو جماعة بغطاء ديني أو طائفي بما يدفع نحو الصدام مع المحيط الاجتماعي، بما يؤدي إلى الانعزال أو الإقصاء، وفي حالات كثيرة ينتهي إلى العنف والإرهاب الفكري والاجتماعي
وعليه فإن ظاهرة التطرف الديني وما يرتبط بها من إرهاب هي ظاهرة عابرة للحدود والأديان والشعوب والمجتمعات والتاريخ، هذا يعني أنها ليست حكرا على دين بعينه، فالتطرف ليس محصورا في دين معين وإن تصاعد في لحظة تاريخية محددة ارتباطا بهذا الدين أو ذاك هنا أو هناك. الحروب الدينية في أوروبا، والحروب الصليبية، إبادة السكان الأصليين في الأمريكيتين، إبادة فرنسا لملايين الجزائريين بما في ذلك قطع رؤوس 500 من قادة الثورة الجزائرية، قبل حوالي 170 عاماً، ولا يزال ماكرون نفسه يحتفظ بجماجمهم في المتحف الوطني الفرنسي في باريس ويرفض إعادتهم الى وطنهم الأصلي، كي يتمّ دفنهم حسب الأصول الإنسانية . هذه مجرد نماذج .
هنا يجدر التنويه إلى أن أي أيديولوجيا، ومهما كان طابعها؛ دينية، سياسية، قومية، عرقية…إلخ، عندما تصبح منظومة ونظام لتشريع الإلغاء والإقصاء ونفي الآخر ستتحول إلى أيديولوجية قاتلة عنصرية ودموية، هذا ما حصل في الأديان، وهذا ما حصل أيضا مع الأيديولوجيا القومية عندما تبنت العنصرية (مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والفكر الاستعماري، وهذا ما حصل أيضا للماركسية كما جرى في تجربة الخمير الحمر في كمبوديا الذين قتلوا ملايين الكمبوديين باسم الماركسية).
لهذا، وكشرط حاسم لا بد من فهم سياقات هذه الظاهرة التاريخية والاجتماعية، وهذا يشترط إدراك فعل الاستراتيجيات المباشرة وغير المباشرة التي تستخدم لضرب الهوية والروح الثقافية لأي أمة، ذلك لأن القوى الأستعمارية أو قوى الهيمنة أو حتى أنظمة السيطرة الداخلية وقبل أن تبدأ بتنفيذ مشاريعها السياسية فإنها تقرأ وتحلل وتفهم واقع المجتمع الذي تستهدفه من حيث عناصر القوة وعناصر الضعف والتناقضات والاختلالات الاجتماعية (لنتذكر أن أحد الدوافع من وراء تأسيس علم الأنثروبولوجيا مثلا كان بهدف جمع المعلومات (باسم البحث العلمي) لمعرفة أعماق الشعوب المستهدفة، معرفة عاداتها، طريقة تفكيرها ومعتقداتها، تقسيماتها الاثنية أساطيرها، تراثها، عاداتها في الأكل، واللباس، الأفراح والأحزان،الاحتفالات، الطقوس، منظوماتها السلوكية، أساطيرها خرافاتها، لغتها، مفاهيمها تجاه الموت والحياة والوطن وظواهر الطبيعة، ومنظومات القرابة والتراتب الاجتماعي …إلخ).
لهذا فإن القوى الاستعمارية (الكولونيالية)، القديمة والمعاصرة، هي أكثر من مارس ويمارس العنف والتطرف والإرهاب بأعلى وأقصى تجلياته عنفا أي إرهاب الدولة المنظم بما يستهدف:
النظم والبنى السياسية للمجتمعات لتحويلها إلى توابع وأداوات وأسواق استهلاكية ونهب ثرواتها الطبيعية.الجغرافية من خلال التقسيم والتمزيق. الاقتصاد من خلال تدمير القطاعات الانتاجية وتحويل المجتمع إلى مستهلك مرتبط بالقوى الاستعمارية التي تمسك بأمنه الغذائي وخلق طبقة وشريحة حاملة لمشروع الهيمنة. غير أن الركيزة الأخطر والأكثر حساسية وتأثيرا التي يستهدفها التدمير أولا وقبل أي شئ هي الثقافة، وذلك بهدف احتلال الوعي الجمعي من خلال تدمير وتشويه ركائز تلك الثقافة ومرتكزاتها المعرفية والحضارية التي تشكل أساس وحدة وتماسك المجتمع وخصائص هويته وتفرده، وبالمقابل إطلاق ديناميات ثقافية نقيضة تعزز ثقافة الاستلاب والعجز والخضوع، بحيث تشكل البيئة الحاضنة للسيطرة على المجال الحيوي الفكري والسلوكي للمجتمع المستهدف، وهذا شرط لتمرير مشاريع الهيمنة وتسويغ التمزيق الجغرافي وضرب وحدة النسيج الاجتماعي.
انطلاقا من ذلك، فقد جرى مثلا، العمل العميق والمتراكم تاريخيا وحتى الآن تجاه الأمة العربية على المحاور التالية: تدمير وتمزيق الجغرافية القومية من خلال: سايكس - بيكو ووعد بلفور (التقسيم) ولاحقا احتلال فلسطين، واستبدال وحدة الأمة العربية بالدويلات القطرية.فك وتركيب البنى الاجتماعية لتمرير الثقافة القطرية من خلال إعادة تظهير الفوارق والتمايزات الاجتماعية والدينية والطائفية والإثنية، ونشر مفهوم الأقلية في وعي كل جماعة، مما أدى لضرب مفهوم الانتماء القومي وتبعا لذلك ضرب مفهوم المواطنة ووحدة الشعب حتى على مستوى القطر الواحد.تدمير وتشويه ركائز الحضارة والثقافة للأمة العربية من خلال التشكيك بها وإحالتها لمرجعيات من خارجها (فارسية، رومانية، يونانية) وزرع المفهوم العنصري بأن العقل العربي هو عقل عاجز ودوني وغير قادر بذاته على التجريد، لأنه عقل ميكانيكي لا يدرك إلأ الملموس فقط، بمعنى أنه متخلف جينيا، ومن ذلك تجري عملية تنميط الأمة أو الشعب المستهدف وتعميم صورة نمطية عنه يجري بناؤها بذكاء وعمق وهدوء: متوحش، غريزي، بشع، لا يؤتمن، حيواني، غدار، رخيص ( يكفي أن نتذكر الصورة النمطية للعربي في أفلام هوليوود الأمريكية…). بهذا المعنى ليس صدفة أبدا تدمير العصابات الإرهابية لروائع مدينة تدمر السورية وآثار العراق وسرقة المتاحف والآثار وتهريبها.
كما هو معروف إن ثقافة أي أمة هي حاصل موروثها الاجتماعي والسياسي والأدبي والفنون والآثار والعادات والمعتقدات ومفهوم الحقوق والموت والحياة… إلخ، وهذه تتشكل عبر عملية تاريخية لا تتوقف، وكل هذا يتجلى في الأساطير والآداب والفنون والأديان. ولو نظرنا لواقع الأمة العربية فإننا سنجد أمامنا كل تراثها وموروثها وحضارتها بما يشمل الأديان القديمة، ومن ثم أهم دينين في العالم العربي الإسلام والمسيحية واليهودية بنسبة ضئيلة. ولكي يمر مشروع الهيمنة كان يجب ضرب بنية الحضارة العربية والثقافة العربية مما يمهد لضرب مفهوم الهوية القومية، وهنا تم العمل على أهم ركيزتين في التكون الحضاري والثقافي لهذه الأمة: الإسلام والمسيحية. ولتحقيق التفكيك والهيمنة ليس هناك أفضل من: وضع المسيحية في مواجهة الإسلام والترويج لمفهوم الأقلية – وتدمير جوهر الدين الغالب وشيطنته ( لهذا ليس صدفة ابدا الإصرار على نشر الكريكاريكاتور المسئ للرسول محمد في أكثر من دولة أوروبية في غمرة ظاهرة الأسلاموفوبيا "الرهاب من الإسلام")، وايضا الترويج بأن الدين الإسلامي هو دين إرهابي بطبيعته، بما يتجاوز 1400عام من تاريخ هذا الدين الأساسي على المستوى الكوني، واختزاله في تجربة بعض ما يسمى قوى الإسلام السياسي" وخاصة تنظيم القاعدة والنصرة وداعش" أو بعض الجماعات والأفراد المتطرفين، اي اختزال الإسلام الذي له كل هذا التاريخ والمنتوج الحضاري والمعرفي بمجموعة من القتلة الذين لا تخفى ارتباطاتهم ووظيفتهم التدميرية ومشغليهم.هنا يصبح بحكم الضرورة التأكيد على أن الدفاع عن المسيحية العربية لن يكون بدون الدفاع عن الإسلام وحمايته، كما أن حماية الإسلام في العالم العربي لن يكون بدون الدفاع عن المسيحية العربية وحمايتها، ومن يصمت على تشويه الإسلام فإنه حكما يمهد لتشويه المسيحية. لقد أدرك التنويريون المسيحيون والمسلمون هذه الحقيقة والخطر فرفعوا راية القومية وحموا اللغة العربية في مرحلة التتريك الطورانية، كما حموا البعد والعمق الحضاري للديانتين الإسلام والمسيحية (ساطع الحصري – البستاني - الريحاني- السكاكيني، عبد الرحمن الكواكبي، شكيب أرسلان ، محمد عبده – الطهطاوي – محمد دروزة – زكي الأرسوزي - ميشيل عفلق - قسطنطين زريق…… وغيرهم ).ما تقدم من أفكار ومقاربات ليس له علاقة بالنقاش البائس الذي ينطلق من محاولة اثبات أن هذا الدين أفضل من الآخر، وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن كل جماعة تؤمن بمعتقد ديني ما، سواء كان سماويا أو غير ذلك ، وحتى لو كانت مجرد قبيلة وليس مليارات البشر فإنها تؤمن بأن دينها ومعتقداتها هي الصحيحة والمحقة بصورة مطلقة.هكذا يجري استغلال الواقع لإطلاق عملية التدمير وضرب اليقين وتفسيخ الوحدة الاجتماعية أو وحدة الشعوب والأمم من خلال خلخلة مكوناتها وضرب نسيجها الاجتماعي والثقافي ومعتقداتها، بما في ذلك الاشتغال على الأديان الموجودة – الطوائف- وتحريك تناقضاتها باسم الحقوق الدينية وحقوق الأقلية والأغلبية. إذن القوى الاستعمارية أول ما تستهدفه سياسيا وفكريا هو هز ثقة الشعب أو الأمة بذاتها، من خلال تعظيم وتظهير التناقضات والاختلافات الداخلية من جانب، ومن جانب آخر إضاءة التقاطعات بين بعض المكونات الاجتماعية والقوى الغازية (مثلا الترويج لمقولة "أن المسيحيين العرب أقرب لأوروبا!".
في هذا السياق أقول لا تبحثوا عن أسباب التطرف الديني في السماء، بل ابحثوا عنها هنا على الأرض؛ لهذا فإن التصدي لأي ظاهرة تطرف أو إرهاب (ديني، سياسي، قومي، إثني، جنسي، ثقافي…) يفرض الذهاب إلى أسبابها وليس الركض إلى الأبد وراء معالجة نتائجها؛ بمعنى التوقف عن الركض لجمع الفطر السام للتخلص منه، بل البحث عن الأسباب التي توفر البيئة والشروط المناسبة لنموه، على حد قول كارل ماركس، هكذا يمكن منع نموه وانتشاره بصورة حاسمة.
في أسباب ظاهرة التطرف الديني:
أولا: الدين والتدين الملتبس
التدين الملتبس هو توسل وتمثل السلوك الديني الشكلي في المظهر والمغالاة في ذلك من أجل فرض حالة من الرهاب الفكري والاجتماعي انطلاقا من العزف على الوتر الحساس في وعي الجماعة البشرية المرتبطة بعلاقة دينية إيمانية. والهدف هو قطع الطريق على النقد وحرية التعبير وممارسة الحقوق الطبيعية للفرد والجماعة، وبهذا تتخلق حالة من الأرهاب الفكري المستند إلى سطوة الدين دون العقل والإقناع.
بهذا المعنى فإن التدين الملتبس هو إجهاض للفاعلية الذهنية بما في ذلك الاجتهاد العقلي العميق في التعامل مع ظواهر وأسئلة المجتمع اليومية شديدة التعقيد، ولكي يسود التدين الملتبس ويسيطر اجتماعيا فهو يدفع وبدأب نحو تعميم الجهل الاجتماعي كأفضل بيئة حاضنة للتدين الشكلي، وهو تدين ميكانيكي يقوم على حرف النقاش والسلوك من خلال التركيز على الشكليات وتظهيرها بما يفقد الدين عمقه الإيماني التأملي الذي عادة ما يكون (أي التأمل) نقطة البداية للتحولات الفكرية والفلسفية، فليس صدفة أن يبدأ مثلا الرسول محمد بالانعزال في غار حراء، واعتزال المسيح في الصحراء لمدة أربعين يوما.
من أخطر انعكاسات ووظائف التدين الملتبس/ أي الشكلي هو تعطيل العقل النقدي، ولهذا فهو يميل دائما لتعميم السلوكيات الطقسية كأداة سيطرة وكبح انفعال وتفاعل العقل، ومن الأمثلة على التدين الملتبس المغالاة والتطرف في أنماط اللباس والتركيز على تفاصيل حركة وسلوك الإنسان وامتلاك الحق بالتطاول على الآخرين بحجة الدفاع عن الدين وكيفية المشي والجلوس والقيام والقعود والأخطر القيود المفروضة على المرأة على مختلف المستويات.
ثانيا: الإخفاق في التعامل مع التناقضات الاجتماعية
سبب آخر للتطرف الديني هو الارتداد الاجتماعي نحو التطرف الديني والاجتماعي في ضوء الفشل في حل مشاكل الناس والمجتمعاتالسياسية والاقتصادية والثقافية وتلبية الحاجات الأساسية، والاختلال في العلاقات الدولية بما يتناقض مع حقوق الشعوب في العدالة والكرامة والحرية والاستقلال.
في ضوء هذا الفشل وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصاية مثل الفقر والبطالة والاستثمار اللاعقلاني للطبيعة والموارد وتفاقم التناقضات الاجتماعية، وفي ضوء التوزيع غير العادل للثروة داخل المجتمع الواحد وعلى المستوى العالمي. كل ذلك وسواه يدفع بالناس للبحث عن حلول في سياقات أخرى وبهذا تتوفر الحاضنة لانتشار التطرف الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي والسلوكي والذهاب للغيبيات الميتافيزيقية.
ثالثا: توظيف التطرف الديني لخدمة الأهداف السياسية والهيمنة
سبب آخر وراء تفاقم ظاهرة التطرف الديني يتمثل في وهم إمكانية استخدام القوى الدينية المتطرفة والسيطرة عليها من قبل الدول لتحقيق أهداف وأجندات سياسية، هذا ما حدث عند دعم حركة طالبان والقاعدة في أفغانستان وهذا ما يحدث جراء دعم الحركة الصهيونية في فلسطين، والعصابات الإرهابية في سورية وليبيا، وهذا ما حدث جراء تعزيز الطائفية في العراق بعد احتلاله عام 2003. وفي هذا الإطار يأتي الصمت والسكوت المهين من قبل الدول التي تدعي الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان على الفكر الديني المتطرف (الفكر الوهابي السلفي) مما شكل حاضنة سياسية وإعلامية ومالية للحركات الإرهابية التي توظف الدين للحفاظ على مصالحها ودورها السياسي.
رابعا:التطرف الديني ومفهوم الوطن/المواطنة والأقلية
من منا ليس أقلية في مواقفه أو انتمائه السياسي أو الفكري أو حتى الجغرافي؟
إذا نظرت لنفسي كعلماني في فلسطين على سبيل المثال فأنا أقلية، وإذا نظرت لنفسي كبدوي فأنا أقلية، وإذا تعاملت مع نفس كمقدسي أو غزاوي أو نابلسي أو خليلي فأنا أقلية، وإذا تعاملت مع نفسي من منطلق سياسي محدد فأنا أيضا أقلية، كما سيكون البريطانيون أو غيرهم أقلية مقارنة بسكان العالم وكذا كل شعب من شعوب الأرض هو أقلية، بل وحتى اتباع الأديان السماوية جميعها مقارنة بغير السماوية والعلمانيين قد يكونون أقلية على هذه الأرض، ولهذا فإن كل واحد ومن زاوية محددة: سياسية قومية فكرية اقتصادية ثقافية هو أقلية.
إذن مفهوم الأقلية هو مفهوم نسبي لا يتناقض بتاتا مع المواطنة. فالمواطنة هي حجر الزواية، وهي نقطة الانطلاق في مواجهة هذه الثقافة والنظرة القاتلة.
تأسيسا على ما تقدم يصبح تحديد أسس ونواظم العقد الاجتماعي الذي يحدد حقوق وواجبات وعلاقات البشر في المجتمع ضرورة وجودية بكل معنى الكلمة. بمعنى أن لكل فرد أو جماعة الحرية بممارسة حياتها وخياراتها وقناعاتها السياسية والاجتماعية والدينية بشرط أن لا تشكل حجزا أو انتهاكا لحقوق وقناعات الآخرين، ومن يسمح لنفسه بانتهاك حرية وحقوق الآخرين فعليه أن يتوقع ردا وسلوكا مماثلا، الأمر الذي يدخل المجتمع والجماعة في دوائر التآكل والتناقض والتناحر الذاتي الداخلي.



















