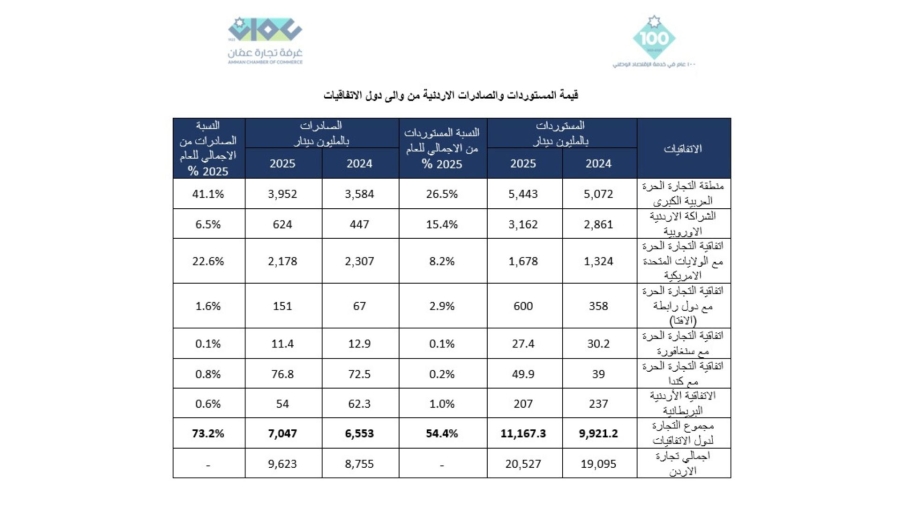التعليم التعليم العاطفي والاجتماعي: نحو بناء الإنسان قبل المنهج

الأب عماد الطوال- ماركا الشمالية
حين يُذكر التعليم، ينصرف الذهن غالبًا إلى المناهج والكتب والامتحانات، وكأن المدرسة خُلقت لتكديس المعلومات في الذاكرة لا أكثر. غير أن الحقيقة الأعمق تؤكد أن المدرسة هي قبل كل شيء فضاء لتكوين الإنسان، ومختبر تتشكل فيه الشخصية، وتُصقل فيه القيم، وينمو فيه وعي الطفل بذاته وبالآخرين. فالتعليم، في جوهره، ليس نقلًا للمعرفة فحسب، بل فعل إنساني شامل يطال العقل والقلب معًا.
وفي عالم اليوم، لا تبدو الأزمة الحقيقية في نقص المعرفة، بل في العجز عن فهم المشاعر وإدارتها، وعن بناء علاقات إنسانية سليمة. ومع ذلك، لا يزال البعد العاطفي والاجتماعي يُعامل في كثير من الأنظمة التربوية بوصفه ترفًا يمكن الاستغناء عنه. وفي هذا السياق يلفت دانيال غولمان النظر قائلًا: «التعلّم لا يحدث بمعزل عن مشاعر الأطفال، فالثقافة العاطفية لا تقل أهمية عن تعلّم القراءة والرياضيات»
التعليم العاطفي والاجتماعي
ولفهم جوهر هذا البعد الإنساني في العملية التعليمية، يمكن التوقف عند عدد من الركائز الأساسية:
أولًا: الاستقرار النفسي أساس التعلّم
لا يمكن لعقلٍ مثقل بالخوف أو القلق أو الاضطراب أن ينخرط في تعلّم حقيقي. فالطالب الذي يعيش توترًا داخليًا دائمًا، مهما امتلك من قدرات عقلية، يعجز عن الفهم العميق والمشاركة الفاعلة. من هنا، يصبح التعليم العاطفي والاجتماعي شرطًا سابقًا للتعلّم الأكاديمي، لأنه يهيئ للطالب أرضية نفسية آمنة يبني عليها معارفه ومهاراته. وقد عبّر الفيلسوف التربوي جون ديوي عن ذلك بقوله: «التعليم ليس إعدادًا للحياة، بل هو الحياة نفسها»، والحياة لا تُعاش بلا طمأنينة داخلية.
ثانيًا: المهارات الإنسانية في زمن التحوّلات
في عصر يتسارع فيه التغيير، لم تعد قيمة الإنسان تُقاس بكمّ ما يحفظه من معلومات، بل بقدرته على الوعي بذاته، وضبط مشاعره، والتعاطف مع غيره، والتواصل بفعالية، وحل الخلافات بحكمة. وكثيرًا ما نرى طلابًا متفوقين دراسيًا، لكنهم متعثرون في إدارة ضغوط الحياة أو في بناء علاقات صحية، وهي فجوة تنشأ غالبًا من غياب التربية العاطفية في سنوات التكوين الأولى. وكما يقول عالم النفس إريك فروم: «الإنسان ليس ما يملك، بل ما هو عليه».
ثالثًا: أثر التعليم العاطفي داخل البيئة المدرسية
تنعكس التربية العاطفية والاجتماعية مباشرة على مناخ المدرسة. فالمدرسة التي تزوّد طلابها بأدوات لفهم مشاعرهم والتعبير عنها بطرق سليمة، تشهد تراجعًا واضحًا في السلوكيات العدوانية ومظاهر التنمّر، لأن الطالب الذي يفهم ذاته لا يحتاج إلى إيذاء الآخرين ليُعبّر عن ألمه. وفي المقابل، يرتفع مستوى التحصيل الأكاديمي، إذ يتيح الاستقرار النفسي التركيز والانتباه والتعلّم الفعّال، وتتحول العلاقات المدرسية إلى علاقات قائمة على الاحترام والحوار والإصغاء، بما يخلق بيئة تربوية أكثر نضجًا وإنسانية.
رابعًا: دور المعلّم بوصفه نموذجًا
لا يمكن للتعليم العاطفي أن يصبح واقعًا حيًّا ما لم يبدأ من المعلّم نفسه. فالمعلّم لا يزرع مهارة لا يعيشها، ولا يعلّم الاتزان العاطفي وهو غارق في ضغط غير مُدار. إن تمكين المعلّم وتدريبه على مهارات التواصل وإدارة المشاعر هو حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي. وعندئذٍ، تتحول المواقف اليومية البسيطة—كخلاف عابر، أو فشل مؤقت، أو نجاح مفاجئ—إلى دروس عميقة في النضج العاطفي، إذا أُحسن التعامل معها بوعي تربوي.
خاتمة
في النهاية، نحن لا نعلّم المنهج فحسب، بل نُشكّل الإنسان الذي سيحمل هذا المنهج إلى حياته. فالنجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الشهادات، بل بقدرة الإنسان على فهم ذاته، واحترام الآخر، والتصرف بحكمة في المواقف الصعبة. ومع كل طفل يكتسب هذه المهارات، نقترب خطوة من مجتمع أكثر وعيًا، وأقل توترًا، وأكثر قدرة على التعايش. ويبقى السؤال التربوي مفتوحًا أمامنا جميعًا:
هل نحن مستعدون للانتقال بالتعليم من “نقل المعرفة” إلى “بناء الإنسان”؟